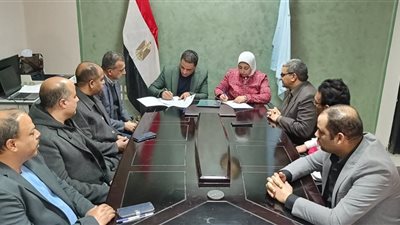محتوى منصات البث الرقمي.. معركة الوعي والهوية

- الشاشات الصغيرة تحولت إلى أدوات لإعادة تشكيل الوعي وتهديد الهوية الثقافية
- منصات البث الرقمي تعيد صياغة القيم وتستهدف النشء والهوية
- الدراما العالمية والهوية المحلية: كيف أصبح الانفتاح غير المنضبط شكلًا جديدًا من الاستعمار الثقافي؟
- الفوضى القيمية تحت لافتة حرية الإبداع في محتوى منصات البث الرقمي
- الدراما الرقمية تعيد تعريف القيم الاجتماعية بعيدًا عن خصوصية المجتمعات
- تنظيم محتوى البث الرقمي ضرورة وطنية لصون الهوية الثقافية
أخطر ما يواجه المجتمعات في هذا العصر ليس الفقر وحده، ولا الصراعات السياسية والاقتصادية فقط، وإنما ذلك التآكل الهادئ والمتدرج الذي يصيب منظومة القيم دون ضجيج، عبر شاشات صغيرة تتسلل إلى البيوت، وتستقر في أيدي الأطفال قبل الكبار، وتعيد تشكيل الوعي الجمعي على مهل، وبلا استئذان.
هذا الخطر لا يأتي في صورة صدمة مباشرة، بل في هيئة اعتياد يومي، وتطبيع بطيء، وتراكم خفي، يجعل ما كان مرفوضًا بالأمس مألوفًا اليوم، وربما مطلوبًا غدًا.
ومن هذا المنطلق توقفت طويلًا أمام ما تطرحه لجان مجلس الشيوخ بشأن تنظيم المحتوى المعروض على منصات البث الرقمي، لا بوصفه ملفًا تشريعيًا تقنيًا، أو نقاشًا إداريًا حول ضوابط العرض والتصنيف، وإنما باعتباره معركة حقيقية على الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، وعلى شكل الوعي الذي سيحكم أجيالًا كاملة في المستقبل القريب.
في تقديري الشخصي، لم تعد منصات البث الرقمي مجرد أدوات ترفيه، أو وسائل عرض بديلة للتلفزيون التقليدي، بل تحولت إلى قوى ناعمة عابرة للحدود، تمتلك قدرة هائلة على التأثير العميق في أنماط التفكير والسلوك، وإعادة صياغة المفاهيم، وتشكيل الذائقة العامة، وتطبيع القيم.
هذه المنصات لا تكتفي بعرض محتوى، بل تقدم نموذجًا للحياة، وللعلاقات، وللنجاح، وللفشل، وللمعنى ذاته، وتفعل ذلك بلغة جذابة، وتقنيات عالية، وسرد درامي شديد التأثير.
الخطر الحقيقي هنا لا يكمن فقط في مشهد جريء، أو لفظ خارج، أو لقطة صادمة، بل في الرسائل المتراكمة، وفي البناء السردي الذي يعيد تعريف الطبيعي والمقبول، وفي التطبيع التدريجي مع أنماط سلوكية وأفكار تُقدَّم في إطار فني جذاب، لكنها تحمل في جوهرها تفريغًا بطيئًا للمعنى، وإزاحة صامتة لمنظومة القيم التي نشأت عليها المجتمعات.
اللافت للنظر أن كثيرًا من هذا المحتوى يُنتج في سياقات ثقافية واجتماعية تختلف جذريًا عن سياقنا، ثم يُبث داخل مجتمعاتنا بلا أي فلترة حقيقية، أو قراءة واعية للفروق الحضارية، وكأن الهوية الثقافية مسألة هامشية يمكن تجاوزها باسم الانفتاح، أو بدعوى العالمية، أو تحت شعار حرية الإبداع.
وأنا هنا لا أدعو إلى الوصاية الفكرية، ولا إلى مصادرة الفن، ولا إلى العودة لمنطق المنع المطلق، لكنني أفرق بوضوح بين حرية التعبير بوصفها حقًا أصيلًا، وبين الفوضى القيمية التي تُمارَس أحيانًا تحت هذا الشعار.
حين نتحدث عن الأخلاقيات الدينية والاجتماعية، فنحن لا نقصد خطابًا وعظيًا مباشرًا، ولا فرض قوالب جامدة على الإبداع، بل نقصد احترام الحد الأدنى من الثوابت التي تشكل وجدان المجتمع، وتمنحه تماسكه الداخلي، وتضمن استمرارية منظومته القيمية.
المشكلة أن بعض المنصات لا تكتفي بتجاوز هذه الثوابت، بل تتعامل مع كسرها باعتباره عنصر جذب وتسويق، وتُعيد تقديم الانحراف بوصفه حرية، والتمرد الأخلاقي باعتباره شجاعة، والتفكك الأسري باعتباره تحررًا، في قلب عملية إعادة تعريف شاملة للمفاهيم.
الأمر الأكثر خطورة، في رأيي، هو ما يتعلق بحماية النشء. نحن أمام أجيال تتلقى ثقافتها الأولى من الشاشة لا من الأسرة، وتتعلم مفاهيمها عن العلاقات الإنسانية، والنجاح، والذات، والجسد، والهوية، من أعمال درامية وسينمائية قد لا تراعي عمر المتلقي، ولا بنيته النفسية، ولا مستوى نضجه المعرفي.
الطفل اليوم لا يشاهد ما كنا نشاهده بالأمس، ولا يعيش نفس السياق التربوي أو الرقابي، بل يتعرض لمحتوى معقد، متشابك، وأحيانًا صادم، دون أدوات تفسير كافية، أو مناعة فكرية تحميه من الالتباس.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: من يحمي هؤلاء؟ الأسرة وحدها لم تعد قادرة على أداء هذا الدور في ظل ضغوط الحياة وتسارع الإيقاع، والمدرسة تعاني من أزمات متراكمة تحد من فاعليتها، والإعلام التقليدي تراجع تأثيره، فكان لا بد أن تتحمل الدولة، عبر مؤسساتها التشريعية والتنظيمية، مسؤوليتها في وضع إطار واضح يحكم هذا الفضاء المفتوح.
تنظيم المحتوى لا يعني إغلاق المنصات أو محاصرتها، بل يعني وضع قواعد عادلة وشفافة، توازن بين حرية الإبداع، وحق المجتمع في حماية قيمه، وحق الطفل في بيئة ثقافية آمنة.
الحفاظ على الهوية الثقافية لا يتم بالشعارات ولا بالخطابات الانفعالية، بل بسياسات ذكية تفهم طبيعة العصر الرقمي، وتتعامل معه بلغة العصر لا بمنطق الخوف أو الرفض المطلق.
نحن بحاجة إلى تصنيفات عمرية صارمة وملزمة، وإلى آليات رقابة مهنية مستقلة، وإلى تحميل المنصات مسؤولية قانونية واضحة تجاه ما تبثه داخل المجال الوطني، أسوة بما يحدث في دول كثيرة تحترم نفسها وهويتها، ولا ترى في ذلك عداءً للحرية.
وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة ماسة إلى دعم الإنتاج المحلي الجاد، القادر على المنافسة فنيًا وفكريًا، لأن الفراغ هو البيئة المثالية لاختراق أي منظومة قيمية.
لا يمكن أن نطالب الشباب بعدم مشاهدة محتوى معين، بينما لا نوفر لهم بدائل جذابة، عالية الجودة، تعبر عنهم، وتحترم عقولهم، وتقدم نماذج إنسانية إيجابية دون مباشرة أو افتعال.
ولا يمكن إغفال البعد الديني في هذا السياق، ليس بوصفه سلطة رقابية أو أداة قمع، بل كمرجعية أخلاقية وثقافية تشكل جزءًا أصيلًا من هوية المجتمع وتكوينه التاريخي.
تجاهل هذا البعد، أو السخرية منه، أو تقديمه في صورة مشوهة في بعض الأعمال، لا يمثل تقدمًا ولا حداثة، بل يمثل قطيعة مع الذات، واغترابًا ثقافيًا يدفع المجتمع ثمنه على المدى الطويل.
إن تنظيم المحتوى المعروض على منصات البث الرقمي ليس معركة ضد الحداثة، ولا حربًا على التكنولوجيا، بل هو محاولة واعية لترويضها، وجعلها أداة بناء لا هدم.
هو اعتراف صريح بأن الحرية بلا مسؤولية تتحول إلى عبء، وأن الانفتاح بلا وعي قد يصبح شكلًا جديدًا من أشكال الاستعمار الثقافي، الأكثر خطورة لأنه يتسلل إلى العقول دون مقاومة.
ومن هنا يمكن القول إن ما يطرحه مجلس الشيوخ في هذا الملف لا يمثل ترفًا تشريعيًا، ولا استجابة عابرة لضغوط اجتماعية، بل خطوة ضرورية في مسار طويل لحماية الوعي الجمعي، وصون الهوية الثقافية، وتأمين مستقبل أجيال تستحق أن تنشأ في بيئة تحترم عقلها، ولا تفرغ روحها، ولا تسرق منها بوصلة القيم.
نحن لا نطالب بمنع العالم من دخول بيوتنا، ولا بإغلاق النوافذ في وجه العصر، بل نطالب بحقنا المشروع في أن نفتح هذا الباب بشروطنا، وبما يتسق مع قيمنا، وتاريخنا، وما نريده لأبنائنا.
وهذه، في ظني، ليست معركة قانون فقط، بل معركة وعي ومسؤولية، إن أحسنا خوضها ربحنا المستقبل، وإن تجاهلناها خسرنا أكثر مما نتصور.